معركة الوعي (171) في مناقشة كتاب يتسحاق رايتر “الحرب والسلام في العلاقات الدولية في الإسلام المعاصر- فتاوى في موضوع السلام مع إسرائيل” (9)
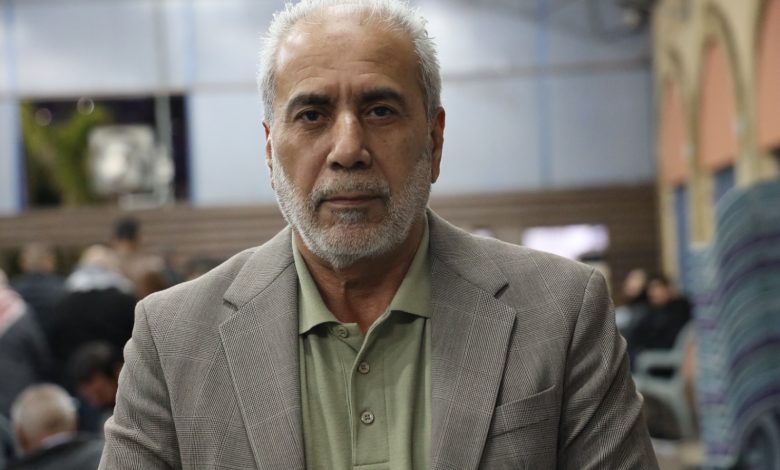
حامد اغبارية
يحاول “يتسحاق رايتر” أن يضع الإسلام في مربّع هو العكس تماما ممّا هو عليه ومما يجب أن يكون. ومن ذلك- على سبيل المثال- ما يقوله (في الصفحة 40) من أن “التطور التاريخي في العلاقة بين الدولة الإسلامية والعالم غير الإسلامي كان مصحوبًا على الدّوام بالاجتهاد الحثيث، من جانب علماء مسلمين، لوضع التحليلات والتفسيرات الّتي تسعى إلى ملاءمة الإسلام لواقع العلاقات الدولية الحديثة، بعدما تحررت الدول الإسلامية من الاستعمار الأوروبي وابتعدت عن العقيدة الجهادية التقليدية، وعبّرت عن قبولها لصلاحيّة القانون الدولي من خلال الانضمام إلى الأمم المتحدة والالتزام بالعيش بسلام جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى والتعهد بالعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية”.
لماذا كل هذا اللف والدوران من رايتر؟
حتى يصل إلى أنَّ كل هذه الحالات تنسحب أو يجب أن تنسحب على علاقة المسلمين مع المشروع الصهيوني الذي تعتبر المؤسسة الإسرائيلية (الدولة) إحدى ثماره.
إن الجهات التي يعتبرها رايتر في العالم الإسلامي على أنها تمثل الإسلام، إنما هي أنظمة وظيفية صنعها الاستعمار لأداء دور. وهذا الدور أهمّ ما فيه هو محاصرة الإسلام كمشروع حضاري يمكن أن يدير دفّة الدنيا من جهاتها الأربع، ومحاربة كل من تسول له نفسه أن يفكر بالعمل على إعادة الإسلام إلى (العقيدة التقليدية)!! ولذلك فإن هؤلاء الّذين يرى رايتر أنهم عملوا على ملاءمة الإسلام لواقع العلاقات الدولية الحديثة إنما هم طعنة في خاصرة الإسلام، لأن الأصل هو ملاءمة العلاقات الدولية للإسلام وليس العكس. أو لنقل قبول الواقع الدولي الحديث للإسلام كما هو، منذ أول للحظة ظهر فيها في جزيرة العرب.، ولو لم يكن الأمر من بدايته هكذا لما قامت للمسلمين دولة، ولما قامت لهم قائمة. ولذلك فإنك عندما تراقب موقف العالم غير الإسلامي اليوم من الإسلام ستجد أن همّه الوحيد هو قلب الموازين، وجرّ الإسلام، كمشروع تغيير عقائدي وحضاري وفكري واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وسلوكي، إلى أدنى سلمّ التأثير في مجريات الأمور على الساحة الدولية. ومن أجل تحقيق ذلك لا بدّ من “ملاءمة الإسلام” للواقع الدولي الحديث. أو بكلمات أخرى أدق تعبيرا: ملاءمة الإسلام للقبول بوجود المشروع الصهيوني والدولة الإسرائيلية.
لذلك فإن رايتر يبحث بسراج وفتيلة، كما يقال في الأمثال، عن أي مبرر، مهما كان واهيًا، يدعم “نظريته”، فيضرب مثالا للحالة الجزائرية تحت الاستعمار الفرنسي، ويقول إن الأمير عبد القادر الجزائري عقد، في العام 30 من القرن الــ19، معاهدات مع الاستعمار الفرنسي بمباركة أحد كبار العلماء في مراكش. ثم يقول: “ما يعنينا في المثال الجزائري أنه جدير بالمقارنة مع الفتوى التي تتناول إمكانيّة السلام مع دولة إسرائيل”.
فهل حقا يمكن المقارنة بين الحالتين؟
إطلاقا!
ففرنسا، دولة مستعمرة فاشيّة صليبيّة مُجرمة، فعلت الأفاعيل بالشعب الجزائري (وسائر الشعوب التي استعمرتها في شمال أفريقيا وبلاد الشام)، وارتكبت أفظع الجرائم ضد البشرية، لكنّها لم تدّعِ حقًّا دينيًّا توراتيًّا أو إنجيليًّا في الأرض الجزائرية، ولم تزعم أن الربَّ وعدها بأرض الجزائر لأن شعب فرنسا شعب مُختار لأنه من نسل يعقوب بن إسحق بن إبراهيم، وأنَّ ربّ الجنود قد منحهم الحقَّ في اقتلاع الشعب الجزائري من وطنه وهدم قراه وتشتيتهم في أصقاع الدنيا، ثم إقامة دولة فرنسية على أرضه! نعم كانوا يسعوْن إلى تنصير الشعوب المسلمة، كما قال أسقف فرنسا الأكبر يومها فريسوس، لأن فرنسا اعتبرت نفسها حامية الكاثوليكية، فكانت حملتها تحمل طابعا صليبيا تبشيريًّا، لكنها لم تدّع أي حق ديني في الجزائر كما فعلت الصهيونية في فلسطين.
أم تُرى أن رايتر – إزاء هذه المقارنة- مستعدٌّ أن يسير حتى النهاية، بأن يَظهر في شعبه “ديغول” الإسرائيلي الذي يقول شعبه: لقد تجاوزنا كل حدّ، واعتدينا، وأخذنا ما ليس لنا بحقّ، ولذلك قررنا الانسحاب والخروج إلى الأبد؟
أما بخصوص المعاهدات التي عقدها الأمير عبد القادر الجزائري، قائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، فإن رايتر يصور المسألة وكأن الجزائري هو الذي بادر إليها عن ضعف وقلة حيلة. لكن الحقيقة غير ذلك.
كانت الجزائر قد وقعت تحت الاحتلال الفرنسي في النصف الثاني من عام 1830 للميلاد. فبعد أن تسلم الأمير عبد القادر دفّة القيادة من والده، بدأ بتشكيل جيشٍ لمقاومة المستعمر الفرنسي. وجرّاء الضربات الموجعة التي وجهها للاحتلال والخسائر الكبيرة التي ألحقها به، اضطر “دي ميشيل”؛ قائد الجيش الفرنسي في مدينة وهران إلى طلب عقد هدنة معه عام 1934 (وليس عام 1930 كما يذكر رايتر في كتابه)، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من مبايعة عبد القادر على الجهاد بهدف طرد الاستعمار من الجزائر. وقد أجبَر عبد القادر في تلك الاتفاقية، وفي اتفاقية أخرى جاءت بعدها بثلاث سنوات، الفرنسيين على الاعتراف بسلطته على غرب الجزائر ومناطق أخرى وسط البلاد (نحو ثلاثة أرباع القطر الجزائري)، لكنهم غدروا ونقضوا العهود، تماما مثل المؤسسة الإسرائيلية في معاهداتها مع الفلسطينيين والأنظمة العربية!! ولا بد من لفت الانتباه هنا إلى أن هذه المهادنات كانت جزءا من معركة متواصلة في الميدان، وليست سياسة استراتيجية اتبعها عبد القادر. فهي أيضا سلاح من أسلحة مقاومة المستعمر. وللتاريخ فإنه لولا غدر سلطان المغرب “مولاي عبدالرحمن” بالأمير عبد القادر وتخليه عنه ورفضه التعاون معه وإمداده بعناصر القوة العسكرية، وخضوعه للتهديدات الفرنسية باحتلال بلاده (التي احتلتها فعلا لاحقا) لتغير مسار التاريخ في تلك الحقبة.
وربما ينفع أن تقرأ ما يلي على لسان رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، حتى تعلم أن تشويه التاريخ لا يمكن أن يخفي الحقيقة:
فهذا رئيس وزراء بريطانيا الأسبق “ويليام كلادستون” يقول عن عبد القادر الجزائري: “حاولتُ بكل ما أملك أن أقنع الأمير السيد عبد القادر الجزائري بمنصب إمبراطور العرب لكي نوظفه ونستغله ضد العثمانيين، وبالرغم من العداء الشديد الذي كان بينه وبين الأتراك فإنني لم أفلح بالرغم من كل الإغراءات والوعود والمزايا التي وضعتها فوق الطاولة للأمير، بما فيها استقلال الجزائر وخروج المحتل الفرنسي من الجزائر، لكنه كان يرفض ذلك جملة وتفصيلا ومن دون نقاش …. حتى دخلني اليأس أن العرب لا يمكن توظيفهم واستغلالهم واستعمالهم، ولكن آخر كلمة أثَّرت في مسامعي وبقيت تدوّي في عقلي وأخبرني أن أنقلها إلى الفرنسيين، أن الجزائر ستتحرر وتنال استقلالها من دون معروف وبركة طرف أجنبي، ولن تجد جزائريًّا بعدي ولا قبلي سيقبل أن يكون خادمًا عندكم أو وكيلا لمخططاتكم، وسيكون استقلال الجزائر العائق الذي لا تطيقونه لعقود من الزمن، ومن أرضنا ستتعثر مشاريعكم، فلست بحاجة لأن أكون ملكًا أو إمبراطورًا أو سلطانًا، فما يهمني بالدرجة الأولى هو أن أواجه المحتل الفرنسي وتغلغلكم في البلاد الإسلامية..”.
وواضحٌ أن الأمير عبد القادر إنما عقد تلك المعاهدات من منطلق القوة كمناورة سياسية يحقق بها هدفه في الاستعداد لما هو قادم من مقاومة المحتل، ولم تكن معاهدات صلح دائم يمنح المحتل حقا في البقاء على شبر واحد من أرض الجزائر. وقد استجاب الأمير للمعاهدة بعد توسلات الجنرال الفرنسي دي ميشيل، الذي أرسل إليه طالبا إطلاق سراح الأسرى، فرفض، فأرسل إليه ثانية، فرفض، فأراد أن يجرب معه التهديد والوعيد، فرد عليه الأمير بما يلي: “أنتم لا تقدّرون قوّة الإسلام، مع أنّ القرون الماضية أعدل شاهد على هذه القوة، وانتصارات الإسلام معروفة لديكم، ونحن وإن كنّا ضعفاء – كما تزعمون- فإن قوتنا بالله الذي لا إله إلا هو، والحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا، غير أن الشهادة في سبيل الله هي ما نصبو إليه، ودويّ القنابل وأزيز الرصاص وصهيل الخيول هي أطرب إلينا من صوت الغواني، فإن كنتم جادّين في الوصول إلى اتفاقية وعقد صلات وديّة بيننا وبينكم، فأفيدونا لنرسل إليكم رجلين من كبار قومنا للمفاوضة…”. (انظر كتاب: سيرة الأمير عبد القادر الجزائري- قائد رباني ومجاهد إسلامي لعلي الصلابي، صفحات 146-155).
أما قول رايتر إن عبد القادر حصل على فتوى لعقد هذه الاتفاقيات من أحد كبار علماء مراكش (ومراكش في المغرب وليست في الجزائر)، فلم أعثر على شيء من هذا، ولكن المؤكد هو أن عبد القادر كان لديه مجلس شورى من كبار العلماء والقادة. وهذا المجلس هو الذي أقر المعاهدات، بعد مماطلة عن سبق إصرار، وبعد أن جعل الجنرال الفرنسي “دي ميشيل” يتوسل لها ويجلس على قارعة الطريق ينتظر قراره بلهفة.
فهل يدرك رايتر حقيقة القوة التي تقف خلف هذا الكلام أو ينطلق منها هذا الموقف؟ وهل يمكن إسقاط هذه الحالة على الصراع على فلسطين؟ هل سمع أحدٌ مثل كلام الأمير عبد القادر أو ما يشبهه أو يقترب منه على لسان السادات في حديقة البيت الأبيض لدى توقيع كامب ديفيد، أو على لسان ياسر عرفات وبعده محمود عباس عند التوقيع على “أوسلو”؟ (يتبع).




