معركة الوعي (138) إسقاط الخيار..
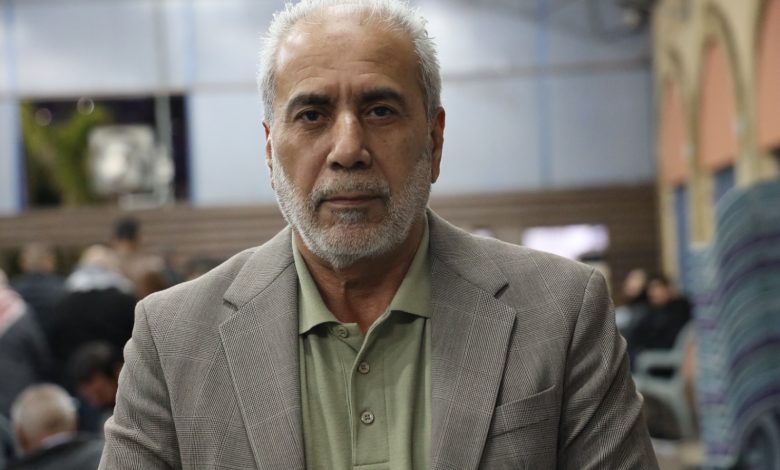
حامد اغبارية
منذ أيامها الأولى التي تلت نكبة الشعب الفلسطيني، سعت المؤسسة الإسرائيلية إلى معالجة قضية أصحاب الوطن الأصليين الذين فشلت في تهجيرهم بقوة السلاح، بوسائل مختلفة؛ أمنية وعسكرية وسياسية وتعليمية واقتصادية، من أجل السيطرة عليهم وتحويلهم إلى مجموعة سكانية منقطعة عن امتدادها الجغرافي والتاريخي والحضاري والثقافي، ومن ثمّ تحويلهم إلى مجرد أقلية. وقد نجحت في ذلك عبر السنوات، في حالة من المدّ والجزر، لكن نجاحها بقي محدودا، إذ لم تتمكن من قولبة فلسطينيي الداخل في بوتقة واحدة أو صهرهم في إطار واحد يمكّنها من السيطرة التامة أو تمرير سياساتها دون أن تواجهها محطات احتجاج أو رفض، كما حدث في يوم الأرض عام 1976 أو أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000، أو كل حدث له علاقة بقضية الصراع على فلسطين، خاصة في القدس والمسجد الأقصى، وأحداث الانتفاضتين الأولى والثانية وسائر الأحداث المفصلية التي عركت مجتمع الداخل وأعادت إليه علاقته بهويته الحقيقة.
وقد كانت المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي إحدى أهم الوسائل التي استخدمتها المؤسسة الإسرائيلية لتحقيق السيطرة على فلسطينيي الداخل. ومن أجل تحقيق ذلك استخدمت قيادات المشروع الصهيوني التي أسست الكيان العناصر العربية التي تواطأت معها قبل النكبة وأثناءها وبعدها، تلك العناصر والأطر التي باعت نفسها للمشروع الصهيوني، فقاتلت معه وساعدته في تثبيت أركانه، حيث جندتها للعمل على جرّ أهل الداخل للالتحاق بالأحزاب الصهيونية (على رأسها المباي والمبام) أو تشكيل قوائم “عربية” تعمل لصالح أحزاب صهيونية لتجنيد الناخبين لصالح تلك الأحزاب.
ليس دقيقا ما قاله ويقوله باحثون في هذه القضية إن الهدف من فتح الطريق إلى الكنيست أمام فلسطينيي الداخل كان فقط لحصد أصوات الناخبين العرب لصالح أحزاب صهيونية. فهذا تفسير يتميز بالسذاجة السياسية والسطحية المفرطة. بل كان تجنيد الأصوات أحد مظاهر المشهد، لكنّ الأهم والأخطر من هذا هو السعي إلى خلق “عربي إسرائيلي” بكل ما في الكلمة من معنى. “عربي إسرائيلي” يفكر ويتصرف ويتعامل ويتحرك ويتعاطى مع كل شيء حوله بأدوات إسرائيلية داخل ملعب السياسة الإسرائيلية. وقد أدركت المؤسسة الإسرائيلية أن تحقيق إنتاج هذا المخلوق المشوّه يحتاج إلى عقود، وإلى عمل متواصل من خلال خطط متعددة الاتجاهات والتخصصات لمسخ عقله وغسل دماغه وإعادة برمجته من جديد.
لذلك لم تكتف بفتح أبواب الكنيست أمام جيل الكبار، وإنما عملت على صناعة أجيال جديدة من سن الصفر حتى المرحلة الثانوية، من خلال مناهج تعليم أعدت خصيصا لأسرلة الفرد الفلسطيني فِكريًّا طوال فترة وجوده في المراحل المدرسية، كما استخدمت وسائل إعلامها كوسيلة إضافية للتأثير المباشر على عقل الفرد الفلسطيني، وفتحت أمامه أبواب الثقافة اليهودية التي وضعتها في مقدمة ثقافات الأمم، وأوهمت الناس بأنها أفضل ما يمكن أن يصل إليها الجنس البشري، وأن الشخصيّة الإسرائيلية (اليهودية) هي النموذج الإنساني الناجح الذي يُحتذى به في مختلف مجالات الحياة، ولذلك هي شخصية جديرة بالإعجاب والتقليد. وفي ذات الوقت عملت على شيطنة الشخصية الفلسطينية والعربية والمسلمة، وقدمتها – سواء من خلال منهاج التعليم أو الإعلام- بصورة سلبية منفّرة لا تستحق الاحترام ، ولا تشكل نموذجا بشريا إيجابيا يمكن الاقتداء به.
ومن خلال هذا المشهد تمكنت الماكنة الصهيونية من إقناع شرائح عريضة من أبناء الداخل الفلسطيني بأن المشروع الصهيوني إنما استردّ حقه في هذه البلاد وأخَذ ما هو تابع له تاريخيا ودينيا، وأنه عاش طوال دهور مظلوما مطاردا، لذلك يحق له أن يكون له وطن، وعلى سائر شعوب الأرض أن تدعمه وتتعاطف معه وتقدم له كل ما يساعده في تأكيد هذا الحق وتثبيته على الأرض.
والعجيب أنها نجحت أكثر ما نجحت في أوساط الذين مارست على آبائهم وأجدادهم كل وسائل القمع التهجير والتشريد أثناء النكبة، حتى أنك تجد من بين أظهرنا من هو كاثوليكي أكثر من البابا، كما يقال. وهذه بحد ذاتها كارثة وطنية وسياسية، وعلامة من علامات ضياع الهوية.
من بين ثنايا هذا المشهد وعبر العقود الماضية تشكلت أطر سياسية عربية بقياداتها وأفرادها، لكنها إسرائيلية الأدوات والسلوك والتفكير، لتخوض ملعب السياسة الإسرائيلي من ذات الباب الذي فتحته المؤسسة الإسرائيلية، وهو باب الكنيست.
وبدلا من أن تسعى هذه الأطر السياسية إلى تغيير اتجاه البوصلة، وإلى مراغمة المشروع الصهيوني، واسترداد الهوية وتصويب الانتماء لأبناء الداخل، وإنقاذ الأجيال من الأسرلة، ومن السقوط في مستنقع المشروع الصهيوني، اتجهت إلى الانصهار داخل البوتقة الإسرائيلية، وأصبح مجالها الوحيد هو اللعب داخل ملعب السياسة الإسرائيلية ومنافسة الحزب الشيوعي (وبعده الجبهة)، إلى جانب منافسة الأحزاب الصهيونية على الأصوات العربية التي ستوصلها بالضبط إلى حيث أراد أصحاب المشروع الصهيوني؛ إلى الكنيست.
لذلك يصلح أن تطلق على هؤلاء جميعا مصطلح “الظاهرة الصوتية” ذات المعنى المزدوج؛ تنافُسٌ على الأصوات، واحتجاج صوتي من على منصة الكنيست.
ولذلك نجد هذه الأطر السياسية الزاحفة إلى الكنيست قد ساهمت في تحويل قضية أهل الداخل الفلسطيني من قضية جزء من شعب وقع عليه ظلم تاريخي، نهبت أرضه وشرد من وطنه وأقيمت على أنقاضه دولة لشعب آخر، إلى قضية أقلية عددية تعاني من هضم حقوقها المدنية واحتياجاتها اليومية، وتتعرض لمظاهر عنصرية من جانب الأغلبية، كما تعاني من الفقر ومستوى المعيشة المنخفض، وأن هذه كلها قضايا يمكن معالجتها، أو تسعى الأطر السياسية الزاحفة إلى الكنيست إلى معالجتها من خلال مؤسسات الدولة الإسرائيلية، بصفة أن هذه الأقلية مجرّد مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة مهضومي الحقوق فيها، أو بوضوح أكثر: أقليّة ظلمتها دولتها!! وعلى هذه الدولة أن تتوقف عن ظلم مواطنيها وأن ترفعهم إلى مستوى الأغلبية!!
هذا السلوك الكارثي هو الذي انتزعنا من المكان الذي يجب أن نكون فيه، وألقى بنا في مكان يجب ألا نكون فيه.
من أجل ذلك فإن أسوأ خيار سار فيه مجتمع الداخل الفلسطيني هو خيار الكنيست الذي صوّرته أحزاب الكنيست الناطقة بالعربية أنه الوسيلة الوحيدة لإحقاق الحقوق، حتى الوطنية منها.
هذا الخيار يجب إسقاطه تماما كخيار استراتيجي.




