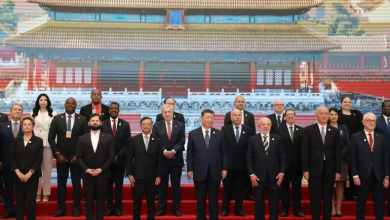معركة الوعي (36).. الذيــــن قالــــوا “لا”! (15)
حامد اغبارية
مدخل
قليلون هم الذين قالوا “لا”! لكنّهم على قلّتهم فرضوا بمواقفهم الثابتة معادلةً جعلت الذين أرادوهم أن يقولوا “نعم” يُجيّشون لهم جيوشا مدججة بكل أنواع السلاح العسكري والاقتصادي والإعلامي والثقافي، سعيا إلى الشيطنة والتشويه والملاحقة والبطش والاجتثاث، فما ازداد الموقف إلا صلابة، وما ازداد المشهد إلا وضوحا، وما ازداد الذين رفضوا السير في الركب إلا عنفوانا، وما ازداد الذين راودوهم عن مواقفهم إلا فشلا، حتى أصبح العالم وقد انقسم إلى فُسطاطين لا ثالث لهما، اللهم إلا من “فُسَيْطِطِ” المنافقين الذين ربطوا مصائرهم بمن يظنون- مخطئين- أنه غالبٌ في كل الأحوال.
في هذه السلسلة التي قد تستغرق صفحات كثيرة، محاولةٌ لفتح البصائر على حقيقة الصراع الدائر بين الذين قالوا “لا”، وبين الذين يريدون فرض أجندتهم على أهل الأرض جميعا، أو بالأحرى فتح البصائر على حقيقة الحرب التي يشنها فسطاط الشيطان على الذين استقر في نفوسهم قول “لا” في كل الأحوال كذلك.
هذا ليس لغزا من الألغاز، ولا هي طلاسم يصعُب فهمُ كنهها. إنه حديثٌ عن أهل الحق القابضين على الجمر في زمن السنين الخداعة التي يُصدّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. إنه حديثٌ عن الذين لم تفارقهم شجاعة المؤمنين ورباطة جأش المرابطين على الثغور، رغم ما يبدو للرائي من ضعف قوّتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس وتخلي الأقربين عنهم.
هو حديثٌ عن تركيا، وعن ماليزيا، وعن الإخوان المسلمين، وعن الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وعن غزة قاهرة الغزاة، وعن العراق ما قبل 2003، وعن العلماء الربانيين الذين رفضوا السير في ركب السلطان، وعن صفحات أخرى مشرقة في بلاد المسلمين التي استهدفها فسطاط الشرّ طوال عقود.
رجالٌ صدقوا… (5)
عماد الدين… (1-2)
إنها قائمة طوية من الذين قالوا “لا”، من الذين صدقوا. وكل واحد منهم يستحق منا أن نفرد له الصفحات الطويلة، لنقدم لهذا الجيل قصته التي يتعلم منها الصبر على البلاء، والثبات على المواقف، والسير إلى الله، غير ملتفتين إلى ما قد يصيبهم من طواغيت الأرض وزبانية التعذيب، همُّهم نهضة هذه الأمة، وتغيير واقعها المؤلم، واستعادة سيادتها للدنيا، لتنشر فيها العدل والقسط، وتخلّصها من براثن الثعالب والضباع التي استأسدت في غياب قوة إسلامية تسد الطريق على أطماعها، وتضع حدا لفتكها بالشعوب والمستضعفين في الأرض. وكم كنت أحب أن أتحدث عن كل واحد من هؤلاء الرجال الرجال، لأن قصة كل منهم مدرسة لا ينضب معينها. ولكنها نماذج قدمنا بعضها على سبيل المثال لا الحصر. ولكن لا بأس من ذكر أسماء بعضهم على الأقل، وفاء لهم واستنهاضا للهمم بهم وبما قدموه. ومن هؤلاء شهيد حرية الرأي والكلمة الحرة جمال خاشوقجي رحمه الله، الذي اغتالته عصابة ابن سلمان في اسطنبول قبل عامين، والدكتور محمد موسى الشريف، ود. عوض القرني، والشيخ محمد صالح المنجد، ود. عبد العزيز عبد اللطيف، والشيخ حمود العمري، والدكتور علي العمري، وهؤلاء في سجون ابن سلمان في بلاد الحرمين، ود. محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر ود. محمد البلتاجي، ود. صفوت حجازي، والشيخ حازم أبو إسماعيل، والشهيد الدكتور عصام العريان، ود. محمود عزت، ود. عبد الرحمن عبد البر، وهؤلاء في سجون عصابة السيسي في مصر. وهذه فقط قائمة جزئية من أسماء يعرفها أغلب الناس، إلا أن أعداد الذين قالوا “لا” للطواغيت” ورفضوا أن يكونوا إمعات أكثر من تملأها الصفحات.
ولعلنا نختم هذه السلسلة، التي أسأل الله تعالى أن تكون قد حققت الهدف منها، بقصة رجل – نموذج من تاريخ هذه الأمة. نموذج يمكننا أن نتعلم منه أنه مهما بلغت الأمة من التراجع والانحطاط والمذلة والهوان والضعف، فإن الأمل في خروج رجال من وسط الألم يبعثون الأمل في نهضة الأمة ويحيونها من جديد، لا ينقطع أبدا.
وإن في التاريخ من العجائب ما يجعلك تقف مذهولا أمام المشاهد المتشابهة بين ما كان بالأمس وبين ما يجري اليوم، وكأنها نسخة طبق الأصل، سوى أن الأسماء والأزمنة مختلفة.
إنها حكاية القائد المسلم عماد الدين زنكي.
في القرن الخامس الهجري كانت الدولة البويهية التي تحمل العقيدة الشيعية قد أوجعت خاصرة الخلافة العباسية. وكاد البويهيون أن يسيطروا على البلاد ويخرّبوا عقيدة العباد، لولا أن شاء الله تعالى غير ذلكـ، فأخرج لهؤلاء القوم الأتراك السلاجقة الذين شكَّل ظهورهم في تلك الفترة محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة. فقد بزغ نجم هؤلاء القوم في أواسط أسيا أواخر القرن الرابع الهجري، وكان همهم إنقاذ دولة الإسلام وحاضرة خلافتها في بغداد مما يحاك لها من مؤامرات، سواء من البويهيين أو الروم البيزنطيين أو المغول. وقد وصل السلاجقة إلى بغداد لا محتلين ولا غزاة وإنما لحماية الخلافة ومنع سقوطها في أيدي أعداء الأمة. وقد عُرف هؤلاء القوم بالصرامة والقوة والنظام العسكري الصارم الذي يصعب اختراقه، إذ عرفوا أنه بغير هذا لا يمكن لهم أن يستمروا ولا أن يحققوا ما يصبون إليه من أهداف رفيعة؛ على رأسها حماية الإسلام وأهله وأراضي دولته. ومنذ اللحظة الأولى أعلنوا ولاءهم للخليفة العباسي، وأن كل ما يحققونه من انتصارات في وسط آسيا إنما هو نصرة للدين تحت راية الخلافة. وبسبب هذا السلوك العسكري الصارم الذي تميزوا به خرج من بينهم قادة أمراء عسكريون أفذاذ سطروا في تاريخ الأمة أروع الصفحات. وكان من بينهم الأمير قسيم المُلك آقسنقر والد القائد الفذ عماد الدين زنكي.
في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري اعتلى عرش دولة السلاجقة السلطان مُلكشاه بن داود، الذي حكم عشرين سنة تعتبر أوج صعود دولته في ظل الخلافة في بغداد. وكان مقر حكمه في الري (إيران اليوم). وقد يندهش القارئ لمّا يعلم أن دولة السلاجقة حكمت مساحات واسعة امتدت من حدود الصين إلى سواحل البحر المتوسط وصولا إلى بحر مرمرة قريبا من القسطنطينية (اسطنبول لاحقا).
كان الأمير آقسنقر من القادة المقربين من السلطان ملكشاه الذي لقبه بـ “قسيم الملك” أي الشريك في الملك، ثم عيّنه حاجبا للسلطان، وهو بمثابة الرجل الثاني في الدولة، وذلك لإخلاصه، ولأجل ما قدمه للدولة السلجوقية من خدمات جليلة.
في تلك الفترة بدأت القلاقل تضرب في الدولة بسبب أطماع بعض الأمراء، وخاصة في بلاد الشام، وتحديدا في حلب.
شهدت مدينة حلب الشام صراعا داميا بين القائد السلجوقي سُليمان بن قُتلَمش وبين تُتش بن داود أخي السلطان ملكشاه، الذي أراد أن يوسع سلطانه ويضم حلب إلى الأراضي التي يسيطر عليها. وفعلا تمكن من هزيمة سليمان ودخل حلب وسيطر عليها، إلا أن تذمّر أهل حلب من سطوة تُتش بلغت السلطان ملكشاه، فسيّر جيشا إلى حلب بقيادته ومعه قسيم الدولة آقسنقر. فاضطر أخوه إلى الانسحاب والفرار، فدخل السلطان حلب وأعاد إليها الأمن والأمان، ثم جعل آقسنقر أميرا عليها، وضم إلى إمارته حماة ومنبج واللاذقية. ومن ذلك التاريخ (479 هجرية/ 1078 ميلادية) أصبحت بلاد الشام تحت حكم السلاجقة، بعد أن كانت قرونا تحت حكم العرب من الحمدانيين والعُقيليين. وكانت حلب قبل وصول ملكشاه إليها تعاني من الاقتتال الداخلي ومن غياب الأمن الشخصي لأهلها بسبب ما أصابها من انحلال اجتماعي وتمزق بين الفئات المتصارعة.
وقد ذكر المؤرخون أن قسيم الدولة آقسُنقر أحسن إدارة حلب، وأباد الدُّعّار، وعُمّرت المدينة، وأمِن الناس على أنفسهم وعلى أشغالهم، وأصبحت حلب محطا للتجار من سائر البلدان، كما بنى منارة جامعها، ونقش اسمه عليها.
ثم لما وافت السلطان ملكشاه المنية دار صراع بين أبنائه على الحكم من جهة، ثم بينهم وبين عمهم تُتش من جهة أخرى. فقد رأى هذا الأخير أنه أحق بملك أخيه من أبنائه. ووجد آقسنقر نفسه بين هؤلاء وهؤلاء، لكنه لما أدرك أنه لن يتمكن من مواجهة تُتش، قرر الانضمام إليه حفاظا على البلاد ومنعا لتدميرها. لكن آقسنقر ومن معه من الأمراء والقادة قرروا سحب ولائهم لتُتش عندما قرر هذا التخلص من ابن أخيه الأمير بِركياروق الذي سيطر على الريّ عاصمة الدولة السلجوقية، وانضم آقسنقر إليه، الأمر الذي حال دون وصول تتش إلى الريّ، حيث تمكنوا من هزيمته وإجباره على الانسحاب إلى دمشق، وقد استقر عنده القضاء على آقسنقر الذي كان سببا في هزيمته. وقد خرج إليه فعلا في جيش كبير سنة 1094 ميلادية وتمكن من سحق قواه، ثم أسره وقتله في نفس اليوم. وهكذا استقر له الأمر في جميع بلاد الشام. غير أن البلاد انقسمت من جديد بعد وفاة تُتش، جراء الصرع بين ولديه رضوان ودُقاق حتى ضعُفت البلاد ضعفا شديدا، ثم لتفاجأ الأمة كلها بالحملات الصليبية التي بدأت سنة 492 هجرية، والتي احتلت مناطق واسعة من بلاد الشام؛ منها الرها وأنطاكية وطرابلس وبيروت وصيدا ويافا وكامل بلاد فلسطين وعلى رأسها القدس. وقد اشتد الصراع بين أمراء الشام، وبسبب ذلك استعان بعضهم على بعض بالصليبيين، حتى مكّنوا لهم في بلاد المسلمين مقابل حماية عروشهم.
في ظل هذه الأجواء القاتمة بزغ نجم الأمير عماد الدين زنكي. (يتبع).