معركة الوعي (143) حول بعض ما جاء في كتاب “قدس أقداسنا/ قدس أقداسهم” ليتسحاق رايتر ودفير ديمنت (1)
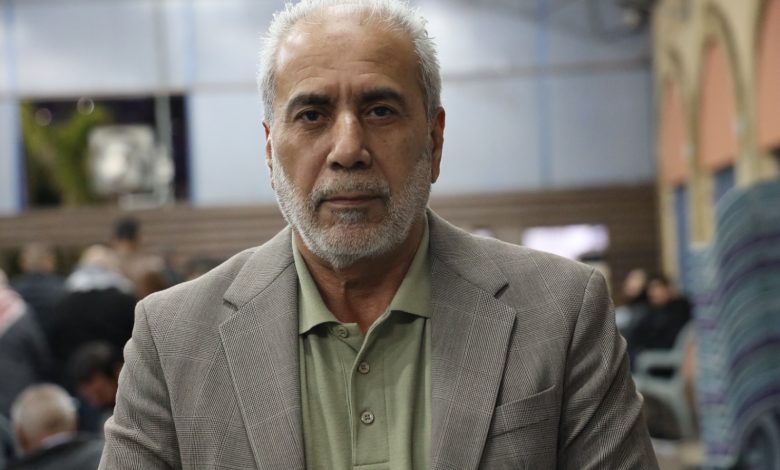
حامد اغبارية
هذه قراءة في كتاب “قدس أقداسنا/ قدس أقداسهم- الإسلام، اليهود وجبل الهيكل” للمستشرقيْن اليهودييْن يتسحاق رايتر ودفير ديمنت. ورايتر هو رئيس الجمعية الإسرائيلية لدراسات الشرق الأوسط ومحاضر في كلية القاسمي في باقة الغربية، وشغل في السابق نائب مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية في حكومات بيغن وشامير وبيرس. أما ديمنت فهو باحث مختص في سياسات الشرق الأوسط والإسلام. وقد صدر الكتاب عام 2020 باللغة الإنجليزية، وترجمه إلى العربية عمر واكد.
من البداية أؤكد أنّ هذا الكتاب محاولة يائسة لإثبات حق اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وأن الهيكل المزعوم موجودةٌ آثاره تحت قبة الصخرة المشرفة، ولذلك فإن المؤلّفيْن بذلا كل وسيلة، وتعلَّقا بكل رواية ذات سند إسلامي لتأكيد هذا الحق!! حتى لو كانت تلك الرواية باطلة أو فيها ما يقال؛ تماما مثل تعلُّق القيادات الإسرائيلية السياسية بأي تصريح بائس دوافعه سياسية بحتة وتحاصره مصالح فئوية، صادر عن هذا أو ذاك من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، مثل التصريح المتعلق بيهودية الدولة أو حائط البراق وما شابه ذلك من مواقف لا علاقة لها بالبُعد الديني أو التاريخي في هذا الملف المرشّح للانفجار في أية لحظة ليميز الخبيث من الطيب.
إن القدس والمسجد الأقصى المبارك وقعا تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أي قبل أكثر من نصف قرن، كان يستطيع الاحتلال خلالها إثبات وجود آثار للهيكل المزعوم في الموقع الذي تمتد فيه مساحات المسجد الأقصى (144 دونما) وخاصة تحت قبة الصخرة. وقد عمل الاحتلال طوال تلك السنوات – وكل شيء تحت سيطرته كسلطة محتلة- حفريات أثرية متواصلة، ما تزال مستمرة حتى الآن، بحثًا عن أثر هنا أو هناك للهيكل المزعوم بالمواصفات المفصَّلة التي وردت في كتبهم المقدسة، لكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من العثور على شيء. والسبب الوحيد لعدم تمكنهم من هذا ليس لأنهم لا يملكون الأدوات والتكنولوجيا لتحقيق هذا، بل لأنه لا يوجد أي أثر للهيكل، ذلك أنه لم يكن هناك هيكل، والشيء الوحيد الذي عثروا عليه في الحفريات لا علاقة له بما يبحثون عنه. ولذلك تجدهم عمدوا إلى إنشاء غرف ومعابد وأنفاق تحت الأقصى تحاكي ما يدور في مخيلتهم.
والآن إلى بعض ما جاء في الكتاب الذي يتضمن نصوصًا يقولان إنها إسلامية لها سند تاريخي اعتمدا عليها لتأكيد حق اليهود في المسجد الأقصى المبارك:
1- جاء في ص17من الكتاب: “… يمكن أن يُستشفّ منها (أي المراجع الإسلامية) أن سبب بناء الأقصى في المكان الذي بُني فيه – موقع جبل الهيكل- نابع من الرغبة الإسلامية في الاستمرارية التوحيدية لقدسية المكان بعد بني إسرائيل”.
أولا: التاريخ لا يُبنى على الاستشفاف وإنما على الحقائق. وعندما “تستشفّ” فأنت تقول عمليا إن هذا الاستشفاف قابلٌ للنقض، لأن غيرك قد يستشفُّ منها أشياء أخرى.
ثانيا: المسلمون لم يتحركوا ولم يتصرفوا بناء على رغباتهم وإنما بناء على منهجية عقائدية مرجعيَّتها القرآن والسنّة. وقضية استمرارية التوحيد تقع في صُلب العقيدة الإسلامية، وهي مطلب شرعي وليست قائمة على رغبة هنا أو هناك. وإنما جاءت لتأكيد وحدانية الله تعالى ووحدانية الدين. إذ في الإسلام ليس هناك دين إلا الإسلام، وإنما كانت هناك شرائع توحيدية مؤقتة (مركزها الإسلام) انتهى زمانها وزمن الالتزام بها بموت النبي أو الرسول الذي جاء بها إلى قومه لتنتقل إلى الذين جاءوا من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلى الرسالة الخاتمة ببعثة الرسالة العالمية برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أو سنّة ربانية من عهد آدم عليه السلام وصولا إلى نوح فإدريس فإبراهيم فإسماعيل فإسحاق فيعقوب فيوسف فداوود فسليمان فزكريا فيحيى فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، وسائر أنبياء الله ورسله إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام إلا جزء من هذه الرسالة التوحيدية التي سعى المسلمون إلى تأكيدها طوال الوقت، كما أكدها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
والاقتباس أعلاه في ربط قدسية المكان ببني إسرائيل محاولة لإثبات ما لا يمكن إثباته لا في النصوص الدينية ولا التاريخية ولا بعلم الآثار.
والحقيقة التي سعى الكتاب إلى إخفائها أن المسجد الأقصى لم يُبن في المكان الذي بني فيه الهيكل المزعوم.
جاء في الحديث النبوي الصحيح:
روى البخاري (3366) ، ومسلم (520) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: “قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟، قَالَ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى)، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً)”.
فلماذا تجنّب المؤلفان إيراد هذا الحديث في كتابهما، والذي يعني أن الأقصى بُني قبل سليمان عليه السلام بعهود طويلة جدا، في زمن آدم عليه الصلاة والسلام؟!
قال ابن الجوزي (في “كشف المــُشكل/360/1):
“الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين وليس أول من بنى الكعبة إبراهيم، ولا أول من بنى بيت المقدس سليمان، وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة، فالله أعلم بمن ابتدأ. وقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم، ثم انتشر ولده في الأرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس”.
ملخص الكلام أن مسجد الأقصى لم يُبن مكان بناء آخر، بل هو موجود بدايةً قبل عهد داود وسليمان عليهما السلام بزمن طويل. أما الحقيقة فإن ما بناه سليمان عليه السلام هو رفع بناء المسجد الأقصى القائم أصلا وبداية، وليس هيكلا مختلفا عن المسجد الأقصى المعروف. وهذا ما يؤكده ابن تيمية (في مجموعة الرسائل الكبرى 2/61): “فالمسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمّي الأقصى، المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب في مقدمته. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد…”.
2- جاء في الكتاب أن محمد بن جرير الطبري (في القرنين التاسع والعاشر) يستند إلى مصادر قديمة تعود إلى القرن الثامن أو السابع. ويبدو أن بدء استخدام المراجع الإسلامية التي تتحدث عن بيت المقدس اليهودي في المكان الذي توجد فيه اليوم قبة الصخرة يعود إلى أيام الخلافة الأموية في فترة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك.
لماذا “يبدو”؟؟؟ لماذا لا يكون المؤلفان على يقين وثقة بخصوص استخدام المراجع الإسلامية من عصر الخلافة الأموية؟ في توثيق الحقائق التاريخية لا يمكنك أن تستخدم ألفاظا احتمالية مثل “يبدو” و “ربما” و “هناك من يقول”، إلا في حالة واحدة: عندما لا تكون هناك حقائق، أو عندما تسعى إلى تزوير الحقائق وإيهام القارئ الذي غالبًا ما لا تستوقفه مثل هذه المصطلحات ويأخذها على أنها حقيقة.
يحاول الكتاب هنا أن يثبت أن الروايات الإسلامية القديمة (التي يستند إليها الطبري) تربط بين اليهود وبين بيت المقدس في المكان الذي توجد فيه اليوم قبة الصخرة. بعبارة أخرى يقول الكتاب إن قبة الصخرة بنيت فوق بيت المقدس الذي هو “هيكل سليمان”! وهذا ما ينقضه التاريخ وما ينفيه حديث بناء المسجد الذي أوردته أعلاه.
3- يستند المؤلفان على روايات ينسبانها إلى محمد بن جرير الطبري في كتابه “تاريخ الرسل والملوك” والمعروف أيضا باسم “تاريخ الأمم” لإثبات روايتهم بخصوص حق اليهود في المسجد الأقصى المبارك. ولعلهما لا يعرفان أن علماء التاريخ المسلمين أمثال الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم إنما كانوا يوردون كل رواية تصل إليهم دون تحقيق في صحتها. وهذه قضية معروفة لدارس التاريخ وللباحثين في التاريخ وخاصة التاريخ الإسلامي. وكان منهجهم في ذلك أن عليهم أن يسجلوا كل رواية يقعون عليها، حرصا على تدوين أكثر ما يمكن حتى لا تضيع الروايات، وأن من سيأتون بعدهم يملكون من الفطنة والذكاء والمعرفة ما يجعلهم يمحّصون ويحقّقون وينقّحون.
نواصل في المقال القادم مناقشة الكتاب، مع استعراض منهجية الإمام الطبري في تاريخه، لبيان أضاليل رايتر وديمنت. (يتبع).




